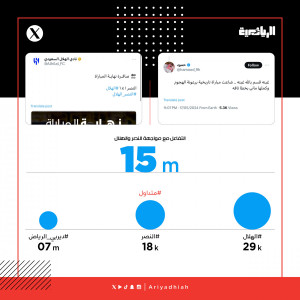للطفولة فرحتها التي لا تشبهها فرحة.. يظل الصغار يعيشونها كألذ حلوى متعددة الأشكال والألوان.
المدرسة هي ميدان العمل الأهم للصغار في أطوارها الأساسية، بدءاً بالمرحلة الابتدائية وما قبلها وانتهاءً بالثانوية.. والبحث عن المرح داخل أسوارها يظل متنفساً لا يتنازل عنه الطلاب والطالبات.
قاعات الدرس أو الفصول كما اعتدنا أن نسميها ما زال يكتنفها قدر كبير من الجدية في ظل أسلوب تعليمي يتجه في مجمله الى التلقين والتقييم والحساب والعقاب!
هنا تأتي (الفسحة) لتحرر الطلاب والطالبات من جمود النشاط التعليمي وضيق أفق وصرامة كثير من المعلمين والمعلمات.. ألم تر الصغار وهم ينطلقون مع جرس الفسحة.. يصرخون في ذهول متجهين نحو الملعب أو (المقصف)!.. كنا قديماً نغني للفسحة.. نهنئ أنفسنا بحلولها وكأنها (العيد).. ففي كل يوم دراسي جديد.. ندور في فناء المدرسة نردد بأعلى صوت: فسحة يا فسحة.. واللي نايم (يصحا).. وليس (يصحو) لزوم (الوزن) فلا تغيرها يا سيادة (المصحح).. بل وتأخذنا السعادة لنضيف في حماسة: (دردبوني دردبة.. حسبوني حبحبة)!
لم يتغير شيء.. ما زال للفسحة مكانتها الكبرى في نفوس طلاب وطالبات اليوم.. تؤكد بأنهم ضحايا هذا الحبس التعليمي الذي لا يؤمن بـ (المرح) كأداة تعليمية بات لا يستغنى عنها في المدارس.. أدرك ذلك ليس لأنني أحمل درجة الدكتوراة في التعليم والتعلم بل لأنني عشت التجربة بنفسي من خلال أبنائي الذين التحقوا بالمدارس البريطانية خلال أكثر من ست سنوات، كان فيها الترفيه والمرح جزءاً هاماً في الحصة التعليمية.. تتسع مساحته في المراحل المبكرة طمعاً في مزيد من الألفة والمحبة بين الطالب والمدرسة، فيراعى في المنهج التعليمي أن يكون بمقدار معقول خوفاً من تسرب الملل الى النفوس. ويأتي الإبداع حينما يتفنن المعلمون والمعلمات في إضافة عنصر الإمتاع على موضوع الدرس ليقبل عليه الطلاب والطالبات برغبة.. تماماً مثلما يفعل الحلواني وهو يضيف (الشيرة) الى (الكنافة) لتصبح (شهية) تذوب في الفم ولا تقف في الحلق فيسهل بلعها وهضمها!
اعذروني أو لا تعذروني سأظل أصرخ (فسحة.. يا فسحة) كما فعلت كثيراً عندما كنت صغيراً.. طامعاً في مزيد من الإفساح (المغرق) بالمرح والإمتاع في قاعة الدرس.
المدرسة هي ميدان العمل الأهم للصغار في أطوارها الأساسية، بدءاً بالمرحلة الابتدائية وما قبلها وانتهاءً بالثانوية.. والبحث عن المرح داخل أسوارها يظل متنفساً لا يتنازل عنه الطلاب والطالبات.
قاعات الدرس أو الفصول كما اعتدنا أن نسميها ما زال يكتنفها قدر كبير من الجدية في ظل أسلوب تعليمي يتجه في مجمله الى التلقين والتقييم والحساب والعقاب!
هنا تأتي (الفسحة) لتحرر الطلاب والطالبات من جمود النشاط التعليمي وضيق أفق وصرامة كثير من المعلمين والمعلمات.. ألم تر الصغار وهم ينطلقون مع جرس الفسحة.. يصرخون في ذهول متجهين نحو الملعب أو (المقصف)!.. كنا قديماً نغني للفسحة.. نهنئ أنفسنا بحلولها وكأنها (العيد).. ففي كل يوم دراسي جديد.. ندور في فناء المدرسة نردد بأعلى صوت: فسحة يا فسحة.. واللي نايم (يصحا).. وليس (يصحو) لزوم (الوزن) فلا تغيرها يا سيادة (المصحح).. بل وتأخذنا السعادة لنضيف في حماسة: (دردبوني دردبة.. حسبوني حبحبة)!
لم يتغير شيء.. ما زال للفسحة مكانتها الكبرى في نفوس طلاب وطالبات اليوم.. تؤكد بأنهم ضحايا هذا الحبس التعليمي الذي لا يؤمن بـ (المرح) كأداة تعليمية بات لا يستغنى عنها في المدارس.. أدرك ذلك ليس لأنني أحمل درجة الدكتوراة في التعليم والتعلم بل لأنني عشت التجربة بنفسي من خلال أبنائي الذين التحقوا بالمدارس البريطانية خلال أكثر من ست سنوات، كان فيها الترفيه والمرح جزءاً هاماً في الحصة التعليمية.. تتسع مساحته في المراحل المبكرة طمعاً في مزيد من الألفة والمحبة بين الطالب والمدرسة، فيراعى في المنهج التعليمي أن يكون بمقدار معقول خوفاً من تسرب الملل الى النفوس. ويأتي الإبداع حينما يتفنن المعلمون والمعلمات في إضافة عنصر الإمتاع على موضوع الدرس ليقبل عليه الطلاب والطالبات برغبة.. تماماً مثلما يفعل الحلواني وهو يضيف (الشيرة) الى (الكنافة) لتصبح (شهية) تذوب في الفم ولا تقف في الحلق فيسهل بلعها وهضمها!
اعذروني أو لا تعذروني سأظل أصرخ (فسحة.. يا فسحة) كما فعلت كثيراً عندما كنت صغيراً.. طامعاً في مزيد من الإفساح (المغرق) بالمرح والإمتاع في قاعة الدرس.