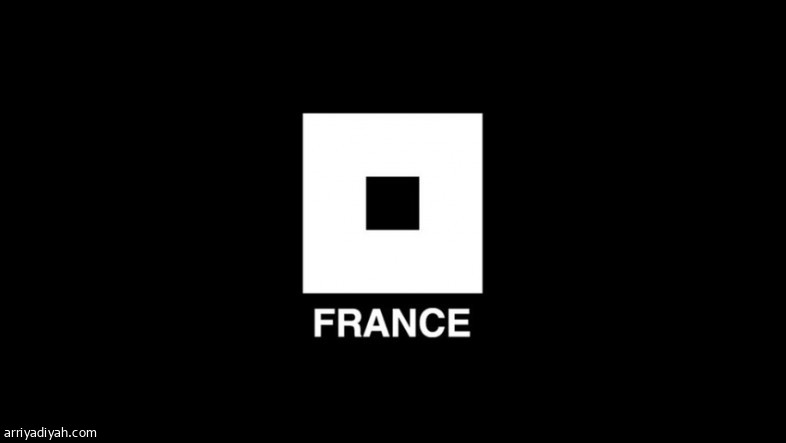ارتفع صوت صفارة الحريق في أحد مراكز التسوق الكبيرة هنا في الدمام.. ولم أر شيئاً على وجوه المتسوقين.. الكل واصل حركته.. حتى صاحبكم اعتراه شيء من البرود.. كنت فقط أترقب أن يتوقف صوت الصفارة لأكمل تسوقي.. وبالفعل توقف الصوت سريعاً واطمأن الجميع أنهم على حق في عدم التسرع وترك المكان، فالمسألة ـ كما هو مألوف دائماً ـ مجرد عطل أو تعد من قبل بعض السفهاء على جرس الإنذار.
هكذا اعتدنا هنا ولا داعي للقلق.. نعم (دع القلق واترك الصافرة ترتفع على كيفها) فليس هناك حريق.. وإن حدث فسيكون بمقدورك أن ترى نيراناَ أو دخاناً أو تشم رائحة.. ربما لمواد كيماوية أو قد تكون لشواء لحوم بشرية.. وإذا ما تأكدت من وجود الحريق انطلق بأقصى سرعة لأي مخرج قريب قبل أن يتدافع الناس ويُسقط القوي الضعيف ويكثر الضحايا!.. هذا ما يحدث عندنا.. أما في الغرب ـ حيث لا تساهل مع ما يهدد السلامة من أخطار الحريق ـ فلا بد أن تعتاد على ترك كل شيء في المكان الذي تكون فيه وتخرج سريعاً حال سماعك لصفارة الإنذار.. وقد فعلت ذلك ـ يوم كنت أدرس في جلاسكو ـ ثلاث مرات خلال أقل من شهر، واحدة منها كانت في أحد مباني الجامعة، ولم يكن الأمر سوى (تجربة) مفتعلة لتدريب الطلبة الجدد على طريقة التعامل مع حالات الطوارئ. أمّا الحالتين الباقيتين فقد كانتا حقيقيتين، وقد تسببت (السمبوسة) الرمضانية في إحداها حين تسرب قليل من الزيت على الموقد الكهربائي لينبعث قدر يسير من الدخان.. لم يكن بتلك الكثافة، ومع ذلك لم يتجاهله جهاز الإنذار الحساس ليطلق العنان لكل الصفارات التي لا تخلو منها غرفة في البيت، لتصم الآذان.. فلم يبق أحد من الجيران إلا وقد غادر المكان.
ولأننا لم نألف على التعامل مع مثل هذه الظروف، فقد تلكأنا قليلاً في الخروج، وإذ برجال الإطفاء وقد اقتحموا علينا الشقة، واتجهوا فوراً إلى مصدر الدخان.
وبعد أن اطمأنوا على سلامتنا.. أكدوا علينا ضرورة ترك المكان عند سماع صفارة الإنذار والتقيد بالتعليمات الخاصة بالسلامة والتي جاءتني مكتوبة في اليوم التالي.
سلامة الفرد عندهم مسؤولية جماعية، لا مكان فيها لـ(فزعات) غير المؤهلين من المتطوعين بل توضع لها من الضوابط ما يكفل تحقيقها بأعلى درجات الحماية.. كل الوحدات السكنية في كافة المباني ترتبط بأجهزة اتصال مباشر بمراكز الدفاع المدني (الإطفاء).. هذا هو السبب الذي أبطل عجبي من تلك السرعة التي جاء بها رجال الإطفاء إلى بيتنا القابع في الطابق الخامس في ذلك المبنى الخالي من أي مصعد كهربائي.
ترى ألم يكن بالإمكان في عالمنا العربي إيجاد مثل هذه الترتيبات والاحتياطات والتجهيزات والقدرات البشرية لحماية أنفسنا من أخطار الحرائق التي تظل ذاكرتنا تحتفظ بالكثير من مآسيها؟
إلى روحي ريم وغدير
هي مأساة بكل ما خلفته.. والخسارة لا يمكن أن تقتصر على إنسان فقد حياته وآخر أصيب.. الخسارة تأخذ بعداً أكبر حين تقف على المشهد وتراه بعينيك أو تستمع إليه بأذنيك.
أما أنا فلا أحب أن أرى.. ولا أن أسمع.. فضلت القراءة.. فغرقت عيناي بالدموع.. من يستطيع أن يقاوم دموعه أمام صور الرحمة التي ملأت قلبي المعلمتين ريم النهاري وغدير كتوعة وهما تواجهان الخطر بعاطفة الأم.. كلنا نحب الحياة ونكره الموت.
حين حضر الموت ليأخذهما كانتا قد أحيتا أمة.. نعم لم يكونوا قلة.. أولئك الذين صنعتا لهم من روحيهما الطيبتين معبراً إلى بر الأمان.. كانوا أمة.. كلنا ندين لهما بفضل.. كلنا نبكيهما ونترحم على روحين جبلتا على الخير.. بلغتا فيه حد الإيثار بأغلى ما يملكه الإنسان.. من قال إنهما ماتتا.. هما عند الكريم بفضله أحياء يرزقون.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
هكذا اعتدنا هنا ولا داعي للقلق.. نعم (دع القلق واترك الصافرة ترتفع على كيفها) فليس هناك حريق.. وإن حدث فسيكون بمقدورك أن ترى نيراناَ أو دخاناً أو تشم رائحة.. ربما لمواد كيماوية أو قد تكون لشواء لحوم بشرية.. وإذا ما تأكدت من وجود الحريق انطلق بأقصى سرعة لأي مخرج قريب قبل أن يتدافع الناس ويُسقط القوي الضعيف ويكثر الضحايا!.. هذا ما يحدث عندنا.. أما في الغرب ـ حيث لا تساهل مع ما يهدد السلامة من أخطار الحريق ـ فلا بد أن تعتاد على ترك كل شيء في المكان الذي تكون فيه وتخرج سريعاً حال سماعك لصفارة الإنذار.. وقد فعلت ذلك ـ يوم كنت أدرس في جلاسكو ـ ثلاث مرات خلال أقل من شهر، واحدة منها كانت في أحد مباني الجامعة، ولم يكن الأمر سوى (تجربة) مفتعلة لتدريب الطلبة الجدد على طريقة التعامل مع حالات الطوارئ. أمّا الحالتين الباقيتين فقد كانتا حقيقيتين، وقد تسببت (السمبوسة) الرمضانية في إحداها حين تسرب قليل من الزيت على الموقد الكهربائي لينبعث قدر يسير من الدخان.. لم يكن بتلك الكثافة، ومع ذلك لم يتجاهله جهاز الإنذار الحساس ليطلق العنان لكل الصفارات التي لا تخلو منها غرفة في البيت، لتصم الآذان.. فلم يبق أحد من الجيران إلا وقد غادر المكان.
ولأننا لم نألف على التعامل مع مثل هذه الظروف، فقد تلكأنا قليلاً في الخروج، وإذ برجال الإطفاء وقد اقتحموا علينا الشقة، واتجهوا فوراً إلى مصدر الدخان.
وبعد أن اطمأنوا على سلامتنا.. أكدوا علينا ضرورة ترك المكان عند سماع صفارة الإنذار والتقيد بالتعليمات الخاصة بالسلامة والتي جاءتني مكتوبة في اليوم التالي.
سلامة الفرد عندهم مسؤولية جماعية، لا مكان فيها لـ(فزعات) غير المؤهلين من المتطوعين بل توضع لها من الضوابط ما يكفل تحقيقها بأعلى درجات الحماية.. كل الوحدات السكنية في كافة المباني ترتبط بأجهزة اتصال مباشر بمراكز الدفاع المدني (الإطفاء).. هذا هو السبب الذي أبطل عجبي من تلك السرعة التي جاء بها رجال الإطفاء إلى بيتنا القابع في الطابق الخامس في ذلك المبنى الخالي من أي مصعد كهربائي.
ترى ألم يكن بالإمكان في عالمنا العربي إيجاد مثل هذه الترتيبات والاحتياطات والتجهيزات والقدرات البشرية لحماية أنفسنا من أخطار الحرائق التي تظل ذاكرتنا تحتفظ بالكثير من مآسيها؟
إلى روحي ريم وغدير
هي مأساة بكل ما خلفته.. والخسارة لا يمكن أن تقتصر على إنسان فقد حياته وآخر أصيب.. الخسارة تأخذ بعداً أكبر حين تقف على المشهد وتراه بعينيك أو تستمع إليه بأذنيك.
أما أنا فلا أحب أن أرى.. ولا أن أسمع.. فضلت القراءة.. فغرقت عيناي بالدموع.. من يستطيع أن يقاوم دموعه أمام صور الرحمة التي ملأت قلبي المعلمتين ريم النهاري وغدير كتوعة وهما تواجهان الخطر بعاطفة الأم.. كلنا نحب الحياة ونكره الموت.
حين حضر الموت ليأخذهما كانتا قد أحيتا أمة.. نعم لم يكونوا قلة.. أولئك الذين صنعتا لهم من روحيهما الطيبتين معبراً إلى بر الأمان.. كانوا أمة.. كلنا ندين لهما بفضل.. كلنا نبكيهما ونترحم على روحين جبلتا على الخير.. بلغتا فيه حد الإيثار بأغلى ما يملكه الإنسان.. من قال إنهما ماتتا.. هما عند الكريم بفضله أحياء يرزقون.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).