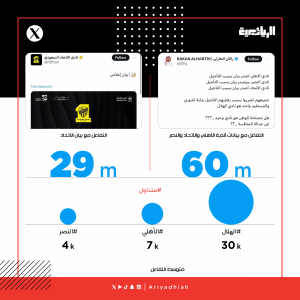ـ "هل تحبّني"؟!، هذا السؤال تحديدًا، وما لم يُقل في غنج داخلي، غنج مع النفس ولها وليس مع الآخر وليس له أولًا على الأقل، أعني حين يكون السؤال استفهاميًّا حقًّا، ويتطلّب إجابة حقًّا، فإنه ليس سؤالًا أبدًا، بقدر ما هو إشارة لإغلاق الستارة، أو إنزال تترات نهاية الفيلم!.
ـ نهاية دون رغبة، أو حتى قدرة على تحمّل مآسيها المُتخَيَّلَة!. سؤال هو محاولة أخيرة، أو شبه أخيرة، للتمسك بالخيط الذي تيقنّ السائل من وهنه، لكنه يريد مساعدة بأي شكل "لكن ليس من أي أحد!" ليتمكّن من تشويه هذا اليقين المُحزن، والمعقود على يقين آخر: أنه لا فائدة ولا مُسَاعَدة!.
ـ سؤال يسأله الأقل رغبةً في الانفلات من الآخر!، مثل من يمدّ يديه لمتعثِّرٍ تأكد سقوطه، أو يركض قليلًا وراء قبّعة طيّرتها ريح عاتية في غياب مصدّات من أي نوع!. يركض خطوتين أو ثلاثًا، وقد تأكد بعد الخطوة الأولى من أنه سيقف، وأن اللحاق بالقبّعة لم يعد ممكنًا، وبالرغم من ذلك يكمل خطوتين أو ثلاث خطوات أخرى في مشهد الملاحقة!.
ـ وحين يتضمن السؤال كلمة ثالثة مُضافة هي "حقًّا"!، فيصير: "هل تحبّني حقًّا"؟!، تكون هذه الـ "حقًّا" أكثر الدلالات على فساد ما جرى، وبُطلان ما تبقّى!. يكون سؤالًا لكَشّ البديهيات!.
ـ الحب، لا يحتاج أدلّة؛ لأنه الدليل الوحيد على ذاته!. طلبُ الأدلّة إدانة وإعلان حكم قاطع بالنفي!.
ـ الكلمات المُناسِبة، الكلمات الصحيحة، الكلمات المُدَرَّبَة على تجاوز العقبات، لا تفيد مع هذا الإحساس في شيء، ولا يمكنها مدّ يد العون للحكاية بأيّ شكل يمكنه الإبقاء على وهج مَسَرّات، أو رعشة داخلية من أثَر الدفء!. يُمكن للكلمات الصحيحة المُدرَّبة على قفز الحواجز أنْ تقدّم فوائدها على طاولة غداء عمل، أو لتهنئة الآخرين أو تعزيتهم!، لها ميادينها، والحب ليس ضمن هذه الميادين!.
ـ عبارات أخرى، ليس مكانها الحب، مثل أن يقول طرف لآخر: "ما الذي يعيبني حتى لا تحبني"؟!، أو: "هات لي سببًا واحدًا يمنعك من محبتي"؟!، أو: "ما الذي تريده، ما الذي يمكن لي أن أعمله لتحبني"؟!. كل هذه التّوسّلات السائلة، خارج السياق، وتلعب في غير أرضها، وهي أقرب إلى الأسئلة التجارية من الأسئلة العاطفية!. أقرب بكثير!.
ـ نهاية دون رغبة، أو حتى قدرة على تحمّل مآسيها المُتخَيَّلَة!. سؤال هو محاولة أخيرة، أو شبه أخيرة، للتمسك بالخيط الذي تيقنّ السائل من وهنه، لكنه يريد مساعدة بأي شكل "لكن ليس من أي أحد!" ليتمكّن من تشويه هذا اليقين المُحزن، والمعقود على يقين آخر: أنه لا فائدة ولا مُسَاعَدة!.
ـ سؤال يسأله الأقل رغبةً في الانفلات من الآخر!، مثل من يمدّ يديه لمتعثِّرٍ تأكد سقوطه، أو يركض قليلًا وراء قبّعة طيّرتها ريح عاتية في غياب مصدّات من أي نوع!. يركض خطوتين أو ثلاثًا، وقد تأكد بعد الخطوة الأولى من أنه سيقف، وأن اللحاق بالقبّعة لم يعد ممكنًا، وبالرغم من ذلك يكمل خطوتين أو ثلاث خطوات أخرى في مشهد الملاحقة!.
ـ وحين يتضمن السؤال كلمة ثالثة مُضافة هي "حقًّا"!، فيصير: "هل تحبّني حقًّا"؟!، تكون هذه الـ "حقًّا" أكثر الدلالات على فساد ما جرى، وبُطلان ما تبقّى!. يكون سؤالًا لكَشّ البديهيات!.
ـ الحب، لا يحتاج أدلّة؛ لأنه الدليل الوحيد على ذاته!. طلبُ الأدلّة إدانة وإعلان حكم قاطع بالنفي!.
ـ الكلمات المُناسِبة، الكلمات الصحيحة، الكلمات المُدَرَّبَة على تجاوز العقبات، لا تفيد مع هذا الإحساس في شيء، ولا يمكنها مدّ يد العون للحكاية بأيّ شكل يمكنه الإبقاء على وهج مَسَرّات، أو رعشة داخلية من أثَر الدفء!. يُمكن للكلمات الصحيحة المُدرَّبة على قفز الحواجز أنْ تقدّم فوائدها على طاولة غداء عمل، أو لتهنئة الآخرين أو تعزيتهم!، لها ميادينها، والحب ليس ضمن هذه الميادين!.
ـ عبارات أخرى، ليس مكانها الحب، مثل أن يقول طرف لآخر: "ما الذي يعيبني حتى لا تحبني"؟!، أو: "هات لي سببًا واحدًا يمنعك من محبتي"؟!، أو: "ما الذي تريده، ما الذي يمكن لي أن أعمله لتحبني"؟!. كل هذه التّوسّلات السائلة، خارج السياق، وتلعب في غير أرضها، وهي أقرب إلى الأسئلة التجارية من الأسئلة العاطفية!. أقرب بكثير!.