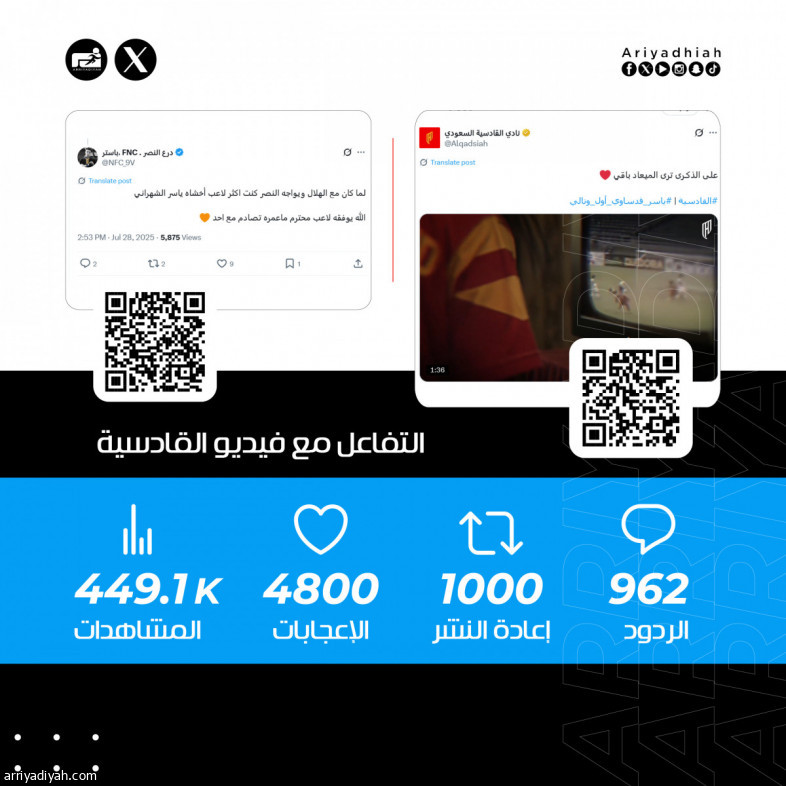أثر رحيل زياد الرحباني إعلاميًا، يعيد التأكيد على أن الموسيقى والأغنية رسالة تسكن في وجدان المستمعين، يصبح الفنان في علاقة صداقة عميقة مع مستمعين لم يلتقهم، صداقة لها ذكرياتها وتواريخها ومشاعرها وأماكنها. تعرفت على أعمال زياد في منتصف التسعينيات، كانت مختلفة تمامًا عن النمط العام، موسيقاه وكلماته من النوع الذي لا تستطيع أن تمزج معه سمعيًا فنانين آخرين في وقت واحد، فنان يفرض عليك حالة تشبهه، ولا يشابهه فيها أحد، بمعنى أنك لا تستطيع أن تصف الوقت الذي تستمع فيه لأغانيه بالقول بأنك تستمع للأغاني، بل تقول: أنا حاليًا أستمع لزياد. أحببت فيه لغته الموسيقية والشعرية، سهل ولكن يصعب تقليده، يكتب الكلمات التي لا ننتبه لها لبساطتها، يجمعها مع موسيقى شديدة الأناقة، يحولهما إلى تحفة فنية تنفذ في الأعماق ولا تغادر، هو من النوع الذي تتعلق به منذ اللقاء الأول، يغيّر في ذائقتك الموسيقية، يضيف لها أبعادًا لم تكن تعرف أنها موجودة في الموسيقى والشعر. زياد الرحباني ولد ليكون فنانًا، لذلك كان نبوغه مبكرًا في أعمال تاريخية قدمها وهو صبي، تمامًا مثل بليغ حمدي، والاثنان يتشابهان في أسطورتهما الموسيقية، مع فارق الزمن والظروف الاجتماعية والسياسية التي كونت كل واحد منهما بشكل مختلف عن الآخر موسيقيًا وفكريًا. زياد الرحباني مع كل أناقته الموسيقية إلا أنه كان فنانًا شعبيًا، لكنها شعبية جمعت الجميع، ورغم قساوة الحرب الأهلية اللبنانية وتدميرها الاجتماعي، إلا أنها أخرجت من زياد لغة ما كانت ستظهر في الظروف العادية، لغة فنية جديدة دخلت تاريخ الأغنية اللبنانية والعربية. مسيرة زياد درس مكتمل عن أثر الموسيقى والأغنية في حياة الشعوب، ودليل على أن القيمة الفنية العالية هي الرسالة الصحيحة، والرهان الناجح للتأثير والبقاء. ربما يراجع بعض المغنين الشباب مسيرة زياد الرحباني بعد رحيله، ليفهموا أن الفن الحقيقي ليس مشروعًا تجاريًا، ولا وسيلة للثراء، بل رسالة لرفع الذائقة الموسيقية والفكرية.